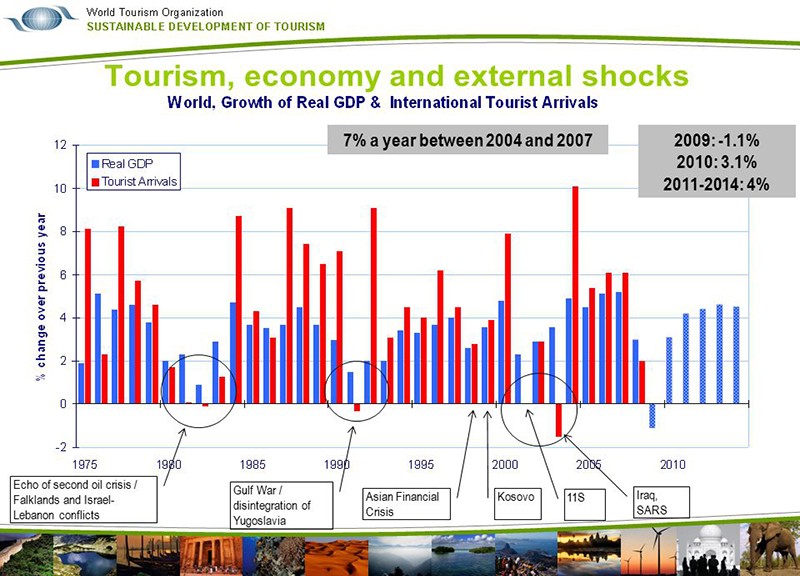رضوان السيد
في التقديم
يعاني المسلمون من سوء علاقاتٍ متفاقمٍ بالعالم، ما عاد متعلقاً وحسْب باصطدام الإحيائيات والأُصوليات بنظام العالم؛ بل تعدّى ذلك إلى صعود ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تعمِّقُ عدم الثقة بهم من جانب شرائح واسعة في الرأي العام العالمي، وتُجرِّىءُ جهاتٍ إقليمية ودولية على استهدافهم في دينهم وديارهم، وفي المغتربات التي اندفعوا باتجاهها خلال النصف الثاني من القرن العشرين. بيد أنّ الاندفاع إلى المهاجر لا ينبغي أن يُنسِيَنا حقيقةً أو حقائق أُخرى. فثلث المسلمين في العالم اليوم، بل ومنذ قرونٍ يتوطَّنون ويعيشون في دولٍ ومجتمعات أكثرياتُها غير إسلامية. وهكذا فكما لا يستطيع المهاجرون العرب والمسلمون، كذلك لا نستطيعُ نحن الاستغناءَ عن العالم المختلف عنا في الدين والثقافة وأعراف العيش والتصرف. ولذلك فنحن لا نُريد ولا نقدِرُ على تقصُّد إخافة العالم، ولا على تعوُّد الخَوف والتوجُّس منه. إنّ مصلحتنا وإنسانيتَنا تقتضيانا السعْيَ لكي نكونَ جزءًا من العالم، ومشاركين في نظامه وحاضره ومستقبله. وبالنظر للواقع الراهن؛ فإنّ ذلك ينبغي أن يدفعَ العلماءَ والعقلاءَ منا إلى تغيير "رؤية العالم" في أوساطِنا شرطاً ضرورياً للتأهُل للعيش في العالم ومعه. إنّ تغيير "رؤية العالم" كما هي مستقرةٌ إلى حدٍ ما في فقه الدين قبل فقه العيش، تعني إقداراً وفتح آفاقٍ على خياراتٍ اُخرى لأمتنا ولديننا ولإنسانيتنا. وسيلاحظ البعض، كما فعلوا في الماضي القريب، أنّ التغيير ينبغي أن يكونَ مزدوجاً، أي من جانبهم ومن جانبنا. لكنّ هذا شرطٌ مُزيَّف. لأنّه يُوهِمُ أنّ الآخرين لا يتغيرون، وأننا وحدنا المطالبون بالتغير. والواقع أنّ القلق يُساورُ الجميع، إنما هناك اجتماعٌ على قواعد أساسية، يحاول بعضُ شبابنا تحدِّيهَا باسم الدين. ولهذا التحدي مستنداتٌ بعضُها موهومٌ، وبعضُها تأصيلي. أما الموهوم فسَنَدُهُ اعتبارُ أنّ الناسَ قد جمعوا لنا، وأنّ هناك مؤامـرةً عالميةً على ديننا وأمتنا. وأما التأصـيلي فهو العودةُ إلى الأصل القرآني وبتأويلٍ معيَّنٍ قد تكونُ له سوابق في التاريخ وفي فهم النص، للردّ على التحدي المفتَرَض! وفي هذا الموطن والمنزع تظهر مشكلتنا في أن نتحدَّى العالم بالقرآن، فنُسيءَ إليه وإلى أنفُسِنا، وإنما المطلوبُ التأهَّلُ والاقتدارُ على وضْع القرآن في العالم أو إعادة عرضه عليه في سرديةٍ جديدةٍ تقتضيها رؤيته باعتباره كتابَ هدايةٍ ونور، وليس سيفاً مصلتاً علينا قبل أن يكونَ على العالم.
-----------------
- أصل هذه الأُطروحة، محاضرة أُلقيت بالمؤتمر الرابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأبوظبي، في 12/12/2017.
I
الاختلالات وتحديات القرن
ما هو الإسلام، أو ما هو الدينُ الإسلامي؟
الدينُ ركنان أو أصلان: الكتابُ والسنةُ، والجماعةُ المتلقيةُ التي تعيش بهما ومعهما، ويجري تزمينُهما من جانب علمائها ومفكريها في المكان والوقت دون أن يُخِلَّ ذلك بتعاليهما، وسريانهما في الزمان. وعن هذه العمليات الزاخرة والجارية في الزمان يتكون فقهان: فقهٌ للعيش، وفقهٌ للدين. وهما يظهران بشكلٍ مُتوازٍ؛ بحيث يشكّل الدينُ فلسفةً ورؤيةً للاجتماع الإنساني الإسلامي وغيره من جانب المسلمين، وهو ما صار يُعرف لدى الفلاسفة المُحْدَثين: برؤية العالم: كيف نرى الخير والشر، والحق والباطل، والحسن والقبح، وكيف نرى إلى العلائـق فيما بيننـا، وإلى العلاقـات مع العالم أديـاناً وأُممـاً ومشتركـاتٍ ومفتـرقات فـي الوجـود والمصـائر. وعلى سبيـل المثـال فـإنّ هذه الــرؤية الملحميـة الشامـلة يراهـا الحسـن البصـري (- 110هـ) عندما يقول: لا دينَ بعد دينكم، ولا أُمة بعد أمتكم، أنتم تسوقون الناسَ، والساعةُ تسوقُكم!
أما فقه العيش، فالمعنيُّ به ترتيباتُهُ وتراكيبُهُ الاجتماعية وألسنتُهُ، وقبل ذلك وبعده قيَمُهُ المشتقةُ من الدين وأفهامِه، ومن المصالح وتكييفاتِها. وإلى التوحيد باعتباره القيمة الأسمى، هناك القيم التي هي أسماءُ الله وصفاتُه، وفضائل العيش أو أخلاقه السلوكية والعملية مثل الرحمة والمساواة والعدل والتعارُف والخير العام. وهناك مفهوما المعروف والمنكَر اللذان تتمحورُ من حولهما حياةُ المجىمع، وهما يتداخلان مع القيم، ويحكمان مفاهيم الخير والشر، ولهما نصيبٌ كبيرٌ أو النصيب الأكبر في فقه العيش؛ بل وفي الجانب العملي من أخلاق العمل والتصرف.
على مشارف الأزمنة الحديثة، شهد فقه العيش اختلالاتٍ تناولت أخلاقَ السلوك والتصرف، كما تناولت أعمالَ الدولة والأنظمة السياسية، وتعاظم التأثر بها، والحطُّ عليها. وقد اختلفت الأنظارُ في أسباب ذلك. فقد كان هناك مَنْ رأى أنّ هذا الاختلالَ إنما حدث بفعل صدمة الغرب، ولا علاقةَ له بالأُصول الدينية والقيمية. ولذلك اتجه الرأي إلى تجديد أو تغيير الجانب السياسي /العسكري من فقه العيش، لمواجهة الأخطار. ومضى الطهطاوي مَثَلاً قُدُماً فرأى ضرورةَ الإصلاح والتغيير في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة. وأبى أن يكونَ هناك اختلالٌ في فقه الدين أو فقه الأصول وتجلياتها الاجتماعية. بينما لم يطْلُبْ خير الدين التونسي من الفقهاء ورجال العلم الديني غير تقبُّل الجديد. وقد استند في هذا المطلب إلى ضرورات المصالح التي كان الطهطاوي قد سمّاها المنافع العمومية. والمنافع العموميةعنده تُطِلُّ على الوعي بالمصالح العامة، إنما ليس من الجانب الديني. في حين رأى التونسي أنّ لهذا الاختلال مساساً بفقه الدين، ولذلك اعتبر أنّ إعمالَ أصل المصالح تارةً، والسياسة الشرعية تارةً أُخرى، كافيان في الإقبال على استحداث المؤسسات، دون أن يعني ذلك المساس بالفقه الديني العام. إنما منذ ثمانينات القرن التاسع عشر اتجهت كلُّ الجهود إلى التجديد في فقه الدين ليتساوقَ مع التجديد في فقه العيش. واتخذ ذلك كله عنوان إزاحة التقليد الفقهي والعقدي، وفتح باب الاجتهاد. وفي الرؤية الإسلامية التقليدية أو الكلاسيكية؛ فإنّ فقه الدين كان هو الذي يحكم ويضبط فقه العيش؛ في حين أدت ضرورات التغيير في فقه العيش وترتيباته قبل قرنٍ ونيف، إلى أنّ تتحكم متغيرات العيش وترتيباته في فقه الدين؛ باتجاه دفعه للتلاؤم معها. وقد تسبَّبتْ وقائع خمسين عاماً وأكثرمن الهجوم على التقليد في تعطُّل أو تعطيل آليات التفاعل والتنسيق بين فقه الدين وفقه العيش، بحيث انهار فقه الدين التقليدي في النهاية، وما أمكن الاصطلاح على بدائل له أو خيارات أُخرى. ويرجع ذلك لعدة أسباب: أنّ جزءًا من الهجمات على التقليد كان لأسباب اعتقادية ما كان يمكن التنازل عنها في نظر أتباعها. وثانياً لأنّ الإصلاحيين ما كانوا متحدين؛ بل كان منهم السلفيون، ومنهم التحديثيون، ومثالاهما شاسعا الاختلاف. هؤلاء يريدون العودة للكتاب والسنة بقصد التأصيل في مواجهة التقليد. وأولئك يريدون العودة للكتاب والسنة لاستكشاف تأويلات جديدة للقرآن تسمح لهم بأسلمة الحداثة الاوروبية أو التلاؤم معها. والسبب الثالث عجز الآليات والأدوات الاجتهادية التي استعان بها الإصلاحيون بقسميهم عن استحداث مناهج جديدة لقراءة النصوص والاستنباط منها غير آليات وأدوات أصول الفقه الكلاسيكية. ولذلك ظلت أُطروحات الإصلاحيين دعاوى ما اكتسبت الشرعنة باعتبارها أقيسة صالحة بحسب جمهور الفقهاء القدامى، أو باعتبارها مصالح مرسلة بحسب المالكية. وعندما نشر محمد الطاهر بن عاشور أواخر الأربعينات كتابه في مقاصد الشريعة، ما جرى الاعترافُ به، وقال كثيرون فيما بعد إنّ فيه تجاوُزاتٍ للنصوص، وتسليماً بأوهام حداثية.
بيد أنّ هذا كلَّه لا يعني أنه وطوال القرن العشرين ما كانت هناك جهود اجتهادية، وجهود للإصلاح والتجديد. وقد قسمتها إلى ست مراحل وفترات: مرحلة مجلة الأحكام العدلية العثمانية، ومرحلة محمد عبده ومدرسته، ومرحلة محمد إقبال ومدرسته، ومرحلة السنهوري ومدرسته، ومرحلة مالك بن نبي ونظرية الحضارة، ومرحلة المصالح ومقاصد الشريعة.
في المرحلة الأولى قام فقهاء العثمانيين ومن أجل التلاؤم، أي تحويل الموروث الفقهي إلى قانون، باجتراح مسألة تقنين الفقه (الخفي) على مثال القوانين المدنية الأوروبية وبخاصةٍ الفرنسي والبلجيكي، فظهرت مجلة الأحكام العدلية. بيد أنّ الأمر تطور بعد ذلك مع ظهور الإحيائيات، فصار تقنين الفقه تقنيناً للشريعة بعد الأربعينات من القرن العشرين.
أما في مرحلة محمد عبده وجيله فقد سادت فكرتان: فكرة السُنَن في قيام الحضارات وانقضائها، وفكرة إصلاح المؤسسات الدينية والوقفية. كان تشخيصه وتشخيص معاصريه أننا نعاني من انحطاطٍ طويل الأمد صار أزمةً حضارية. وللنهوض الحضاري الذي يتضمن نهوضاً سياسياً واجتماعياً ودينياً سُنَن أو قوانين، ولا يحدث بصورةٍ عجائبية، فينبغي بعد التشخيص وبالمقارنة مع النهوض الأوروبي من السير قُدُماً في استحضار أسباب وآليات وعوامل النهوض. وما اعتبر محمد عبده الفصل بين الدين والدولة من دواعي النهوض، كما قال في ردّه على فرح أنطون. لكنه رأى أنّ المؤسسات الدينية والمحاكم الشرعية والأوقاف جميعاً في حالة انحطاط، لخضوعها لأهواء السلطات، ولأنها تجمدت على التقاليد القديمة. وقد اعتقد أنه بالعمل على أسباب النهوض في الأمة بالتعليم والتجديد السياسي، واستقلال المؤسسات الدينية، يمكن أن يجري من ضمن النهوض المرتَقَب تجاوز التقليد العقدي والفقهي وإنتاج أجيال جديدة من العلماء في مؤسساتٍ تتسم بالاستنارة والصلاح.
ولو أقبلْنا على دراسة المسائل التي نجح عبده في إحقاقها لربما لم نجد الكثير. لكنه نجح في بعث روحٍ وثابةٍ دافعة باتجاه النهوض ومن قلب الإسلام وثقافته. بيد أنّ مدرسته أو أعلامها ورغم بقاء الفكرة العامة بشأن النهوض قوية في أوساطهم؛ فإنّ الأولويات لدى جيل المدرسة الثاني اختلفت بل تناقضت. فاتجه البعض لمسألة فصل الدين عن الدولة لمنع الدين من الاعتداء على الدولة المصرية الدستورية الجديدة (علي عبد الرازق وطه حسين ومنصور فهمي وآخرين). كما اتجه البعض الآخر مثل رشيد رضا اتجاهاً معاكساً بإبراز الدور الذي ينبغي أن يكون للدين في الدولة الوطنية الجديدة. في حين مضى طرفٌ ثالثٌ باتجاه إدانة محمد عبده ومدرسته باعتبارهما ماسونيةً وتغريباً. وأعانت على هذا الانقسام ظروف الحرب الأولى وما بعدها حيث اكتملت سيطرة المستعمرين على أقطار العالم الإسلامي.
إنّ المشروع الآخر أو الثالث بعد مشروع محمد عبده هو مشروع المفكر محمد إقبال، في كتابه: تجديد التفكير الديني في الإسلام. وقد تميز إقبال الذي درس بألمانيا وإنجلترا بتوسيع الأُفق عندما ضمّ إلى التأويلية في تأمل النصوص الدينية من وجهة نظر رؤية العالم: اعتبار التاريخ أو تجربة الأمة في التاريخ، ليكون ذلك كله أساساً في التشخيص، وفي اجتراح المخارج. ومن ضمن هذا التوسيع النظر إلى الحركات الإسلامية الجديدة بإيجابية، باعتبارها جميعاً محاولاتٍ للتجديد والتصدي للمشكلات التي أتت من مواريث القرون أو من غزو الغرب للعالم. لكنّ إقبال النهضوي والتجديدي وقف للمرة الأولى أمام عقبةٍ كأداء، صارت همَّ الهموم على مدى العقود اللاحقة وحتى اليوم، وهي عقبة الهوية. فالمسلمون بموازين العدد (ورغم أنهم حكموا الهند قروناً ) ظلّوا أقلية فيها. ووسط يقظة الروح القومية في الشعوب المستعمرة، وظهور المؤتمر الهندي الذي تزعمه غاندي بفلسفته اللاعنفية؛ فإنّ قلقاً عميقاً ساور المسلمين السادة سابقاً، على دينهم وعلى حرياتهم، رغم مساعي غاندي الكبيرة للطمأنة والمشاركة. ولذلك فإنّ محمد إقبال المتوسع في تأويل النصوص، والفاهم للتاريخ والحضارات؛ كان يريد إنشاء دولٍ مستقلةٍ عن الاستعمار، وتتمتع بميزات الحداثة؛ لكنها إسلامية. وهناك جدليةٌ شديدةٌ ومعقَّدة في تفكيره تتناسبُ وثقافته الفلسفية الواسعة، لكنه صار معتبراً الداعية الأول لأنشاء باكستان المنفصلة، رغم وفاته عام 1938. لقد نُسيت تجربةُ إقبال في ربط النص وتأويلاته بالتاريخ، وبقي له وعنه إبداعه الشعري، وإدراكه لاهمية الهوية والخصوصية في الوعي والمصائر. وهو الأمر الذي تسلّمه أبو الأعلى المودودي زعيم الجماعة الإسلامية، وعلى يديه تطورت أطروحة الدولة الإسلامية، التي مضت باتجاهاتٍ ما فكر بها إقبال بالتأكيد.
أما المشروع التجديدي الرابع فهو مشروع الفقيه القانوني الكبير عبد الرزاق السنهوري. وكان قد درس القانون بفرنسا، وكتب أُطروحته عن الخلافة عام 1926. ومع أنه كان قد اقترح الشريعة قانوناً للدولة الوطنية الجديدة بعد التقنين وإجراء الإصلاح الجذري عليها؛ فإنه وطوال أكثر من ثلاثين عاماً سعى لتلاؤميةٍ وامتزاج بين القانون المدني وموروثات الفقه الإسلامي. وكان سعيداً بهذه التوفيقية التي اعتبرها استعادةً للثقة بالنفس وبالدين، وإثباتاً للكفاية والإبداع من جانب الفقهاء المسلمين القُدامى. وقد تأسست على يديه مدرسةٌ من القانونيين المصريين وغيرهم ظلت تؤثر حتى الثمانينات من القرن الماضي في التعليم بالجامعات، وفي التأليف في مسائل إدارية ودستورية لها علاقة بالتاريخ، ولها علاقة بالفقه القديم.
بيد أنّ مشروعه التلاؤمي الواسع، الذي كتب فيه كثيراً، دخلت عليه تأويلاتٌ في حياته ما اعترض عليها هو، من جانب الذين فصلوا فصلاً قاطعاً بين الشريعة الإلهية، والشرائع الوضعية. ثم جرى فهم آراء السنهوري أو مسالكه في الاجتهاد باعتبارها دالّةً على اعتبار شرعية الدولة والنظام الجديد متعلقةً بتحول الشريعة إلى قانونٍ للدولة. فازدهرت مشروعات تقنين الفقه، وصار الفقه المقنن في موادّ على طريقة مجلة الأحكام العدلية العثمانية هو الشريعة ذاتها، وصار تطبيقها ضرورياً لبقاء الدين وشرعية الدولة، وكل ذلك في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وهكذا فإنّ المصير الذي آل إليه مشروع إقبال النهضوي، آل إليه أيضاً مشروع السنهوري على يدي الحزبيين الإسلاميين دُعاة الدولة الإسلامية، وتطبيق الشريعة.
والمشروع التجديدي الخامس هو مشروع المفكر الجزائري مالك بن نبي. وهو أكثر من محمد إقبال يطرح نظريةً في الحضارة. وهو متأثر برؤية شبنغلر في التدهور الحضاري الغربي، ورؤية أرنولد توينبي في التحدي والاستجابة الحضارية. لكنه ينطلق مثل المشارقة الآخرين من مقولة الانحطاط في حقبة ما بعد الموحِّدين، ومقولة القابلية للاستعمار نتيجة الاختلال الذي حصل بين عناصر الحضارة في عالم الإسلام. ومع أنّ الاختلال بحسبه ذهني وتفكيري؛ فإنه يثق باستراتيجيات عدم الانحياز والحياد الإيجابي، ويريد إقامة متَّحد حضاري مع الحضارات الشرقية الناهضة بمشروعات سياسية تحررية، ويعتبر العرب عبر الثورة المصرية، شركاء فيها. ورغم تضاؤل آماله بثقافة "المناعة" العالمثالثية بعد منتصف الستينات، وخوفه من انفجار العنف بداخل الإسلام؛ فإنه ما تدخل في عمليات مكافحة التقليد، أو القطيعة مع الموروث، والتي صارت زاداً ضخماً في حقائب المثقفين العرب ومشروعاتهم الشاملة.
وما تزال كتاباته، هو الذي توفي عام 1975، لها شعبيتها بين المتدينين من الشبان والكهول باعتبار نزعتها التحديثية المعارضة للغرب وغزوه الفكري والثقافي. بيد أنّ الاهتمام العملي أو النزوع التقني والتطبيقي، والذي سيطرت فيه ثقافة الإحيائيات والأُصوليات، منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، نحّى تلك الكتابات التأملية عن دائرة الأولويات لصالح مقولة تطبيق الشريعة، وإقامة الدولة، ومصارعة العالم.
ويبقى المشروع السادس أو المرحلة السادسة من مراحل التجديد الديني أو تغيير رؤية العالم من طريق خطابٍ جديد. وأعني بذلك مقولة مقاصد الشريعة، وضرورياتها الخمس، أو المصالح الضرورية. وقد كانت لها مصادر ومصائر ووظائف مختلفة خلال أكثر من قرنٍ من الصعود والخفوت بعد أن دعا إليها الطاهر بن عاشور في الأربعينات. وهي عندما طُرحت خلال العقود الثلاثة الماضية بعد بن عاشور وعلاّل الفاسي صارت لها غاياتٍ تواصُلية؛ وبخاصةٍ من جانب الكبار وبخاصةٍ العلاّمة الشيخ عبدالله بن بيه، لقد استخدمت في الثمانينات والتسعينات في إنجاز إعلانات إسلامية لحقوق الإنسان بقصد المشاركة في القيم العالمية التي ظهرت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فنحن نملك – بحسب مفكّري وفقهاء المقاصد- قيماً ومبادئ نحن مُلزَمون بها في ديننا، وملتزمون بها تُجاه العالَم. وصحيح أنّ بعضَ الذين كتبوا في المقاصد كانوا يريدون تشجيع الاجتهاد أو الفخار بالتفوق والخصوصية. بيد أنّ التوجه الرئيس هدف للمرة الأولى لفتح منفذٍ وأفق جديد للاجتهاد والنهوض، وللتفكير في علاقاتٍ أُخرى مع العالم غير علاقات الحرب والصراع، بل صارت فكرة المقاصد أو رؤيتها ظاهرةً في قلب خطابٍ جديدٍ للسلام والتعاون والتصالح من جانب المسلمين مع البشرية ومع نظام العالم وإعلاناته. وسنعود لذلك.
II
لماذا فشل التجديد؟
قلنا من قبل إنّ الاختلالات التي طرأت على فقه العيش وترتيباته في المجال الإسلامي نتيجة المتغيرات الهائلة والعاصفة، جرت الاستجابة لها على مدى قرنٍ وأكثر من خلال محاولاتٍ متواليةٍ للتجديد في فقه الدين. وقد اعتبرتُ المحاولات الست التي لخّصتُ أفكارها الرئيسة أهمَّ تلك المشروعات أو لنقل الاستجابات. بيد أنّ النجاح أو الاستتباب لم يحالف معظمها لأنها واجهت تحدياتٍ كبرى داخلية وعالمية، ولأنها في معظمها عملت من منطلق الأزمة الحضارية، ولكنها ما اقترحت رؤيةً شاملةً لمواجهة تلك الأزمة. ولأنها كانت جزئيةً في استتناجاتها وحلولها. ولأنّ الأصوليات والإحيائيات طرحت في مقابلها رؤيةً شاملةً للدين في ماهيته وأدواره ووظائفه حظيتْ بتأييد نُخَب فكرية ودينية على مدى أربعة عقود.
لقد أتت التحديات في البداية والنهاية من جهتين: السياسات الدولية، والتي أدت في طغيانها وهول آثارها إلى اعتبار الجمهور ومثقفيه كلّ محاولة فكرية أو سياسية للانفتاح، بمثابة استسلامٍ أو تآمُر- وأنّ التجديدات الجزئية التي طرحها مفكرون أفراد، ما لقيت فئاتٍ أو مدارس أو مؤسسات حاملة ومطوِّرة، مثلما حدث في المذاهب الفقهية أو الكلامية في القديم على سبيل المثال- وأن الدول الوطنية الجديدة والتي بدأت بالظهور بعد الحرب الأولى، ما وجدت عُمُراً وزمناً للنجاح على مستوى تكوين المؤسَّسات، ومستوى العلاقة المستقرة بالجمهور. وعندما كان ذلك كله يحدث مما بعد الحرب الأولى وحتى الستينات من القرن العشرين؛ كانت الإحيائيات والأصوليات تنمو وتمتد بين الجمهور، وتشتغل على فقهٍ جديدٍ للدين أيضاً، يواجهُ متغيرات فقه العيش؛ ومن ضمن ذلك مواجهة العالم باعتباره معتدياً على الدين وعلى الناس. ويمكن تركيز ذلك الوعي المحبط والثائر والمتأزم في عدة نقاط:
- أنّ هناك مؤامرةً على الإسلام والأمة، ومن ضمنها السلطات الوطنية التي بدأت تتكون في أوساط النُخَب المدينية، وتحاول المزاوجة بين الكفاح السياسي والشعبي ضد الاستعمار، وإقامة المؤسسات والممارسات المعتادة في دول الغرب الحديث.
- أنّ " الشرعية" السياسية لأي نظامٍ لا تستند وحسْب إلى تأييد الجمهور، بل لا بد أن تكون أمينةً للهوية الإسلامية للمجتمع.
- أنّ الإسلامَ دينٌ ودولة. وهكذا فإنّ الدين الإسلامي يملك مشروعاً سياسياً لا بد من إحقاقه باعتباره ركناً من أركان الدين. وعلى مدى أربعين عاماً وأكثر ظهرت أدبياتٌ هائلةٌ عن النظام الإسلامي الكامل في الاقتصاد والقانون والاجتماع والسياسات الداخلية والأُخرى الخارجية. وصار ذلك كله متركزاً في ضرورة "تطبيق الشريعة" من أجل استعادة الشرعية للدولة والمجتمع، فتضاءلت إلى حدود الاختفاء الرؤية الإنسانية والكونية للدين، لصالح ربطه بإقامة نظام سياسي من جهة، ومصارعة العالم من جهةٍ أُخرى!
- أنّ الحائل دون إقامة الدولة الإسلامية الشرعية السلطات الداخلية المتغربة، والنظام الدولي الحامي لها. ولذلك ينبغي الكفاح ضد الطرفين بشتى الوسائل، لأنّ الدين معرَّضٌ للخطر، وكذلك المجتمعات!
- أدّت الحرب الباردة التي زادت من الاستقطاب، إلى إفادة حركات "الصحوة" هذه من جوانبها الثقافية والأمنية والعسكرية؛ بحيث تغلغلت الصحوات في الأوساط الاجتماعية، وبحيث نجحت في تحطيم الدولة الوطنية في إيران، وإثارة إضطرابات باسم الدين في المجتمعات العربية والإسلامية÷، ومجتمعات العالم، وذهبت للقتال في أفغانستان، وصارت لها تجاربها القتالية التي زادت من طموحاتها.
وما مورس التفكير النقدي الجدي من جانب الإصلاحيين في بحث المفهوم الجديد التحريفي للشريعة، ولا في صحة مقولة الإسلام دين ودولة، ولا في أنّ النظام السياسي ليس ركناً من أركان الدين. وإنما كان هناك تركيزٌ من جانب الإصلاحيين المسلمين ومنهم ذوو الثقافة الفقهية والعقدية على تحريم العنف بالداخل، ومطالبة الدول بالفعل بتطبيق الشريعة لسحب الريح من أشرعة الإحيائيين والحزبيين!
- وأخيراً وليس آخِراً ذاك الفصام الذي شاع وتجذر بين الإصلاحيين والجذريين الإسلاميين من جهة، والمثقفين العرب الكبار من جهةٍ ثانية. فقد تكاثرت مشروعات المثقفين العرب للخلاص من الموروث الديني باعتباره عائقاً دون الدخول في الحداثة، وتارةً بتحريره من أوهام العامة، وطوراً بتحرير العامة منه. وهكذا ساد انقسامٌ محبطٌ بين مَنْ نُبزوا باسم العلمانيين، والآخرين الذين استأثروا باسم الإسلاميين.
III
السردية الجديدة ومقولاتها
إنّ الوضع الخطير والمتمثل في تحول الإسلام إلى مشكلةٍ عالمية، وتهديد الانشقاقيين للدول الوطنية ولوحدة المجتمعات، ولبقاء الدين على سكينته باعتباره العاملَ الرئيس في ثقة الناس ببعضهم، وثقتهم بربهم وأوطانهم، وعلاقاتهم ببني البشر؛ كلُّ ذلك يقتضينا الذهابَ باتجاه سرديةٍ جديدةٍ في الدين وللدين، تتجاوز تجديد الخطاب فيما يتعلق بالعنف تجاه النفس والغير فقط، وتجترح فلسفةً جديدةً للدين، وسلاماً مع النفس والعالَم.
ماذا يقتضيه ذلك؟ يقتضي ذلك إنجاز أمرين: الأول: الانتقال من مرحلة نقد النص، وتقديس الموروث أو إدانته من أجل الدخول أو الإفضاء إلى تأويليةٍ كبرى، لا تعتمد التأصيل، كما لا تعتمد النقديات الجذرية على طريقة التاريخانيين أو المراجعين الجدد. المنطلق هو الفهم الشامل والتجاوُز بدون إنكارٍ أو قطائع، ولا اللجوء إلى عجائبيات اللامفكر فيه، بل إلى المفاهيم المركزية في الدين.
والثاني: الإسلام يعتبر نفسه دين الأمة الوسط: { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس، ويكونَ الرسول عليكم شهيدا}( سورة البقرة: 143). وسبيل الأمة الوسط له ركنان: الكلمة السواء: { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم أن لا نعبد إلاّ الله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}(سورة آل عمران: 64)، والركن الآخر: إلتزام المعروف فكراً وقولاً وعملاً { ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون(سورة آل عمران: 104). فالمعروف يُعاد تحديده في كل عصرٍ من جانب جماعة المسلمين في ظروفها التاريخية ووعيها المتجدد بمصالحها وبالعالم ومعه. وهكذا فنحن ومنذ تصدع الإجماع على فقه العيش وفقه الدين، نسعى منذ قرنٍ ونصف وأكثر على الوصول لإجماعٍ جديدٍ على المعروف الأصيل في مقولة الخير، والجديد في إمكانيات التلاؤم، نعيش به مع العالم وفيه. وهذه عملية مستمرة لا تتوقف.
لهذه الاعتبارات كلّها توصلت إلى ثلاث مقولاتٍ أساسية تقوم عليها السردية التأويلية الشاملة للدين، وهي:
المقولة الأولى: أنّ القيمة العليا في علاقة الله سبحانه ببني البشر هي قيمةُ الرحمة. وهذا ظاهرٌ وواضحٌ في مثل قوله تعالى:{ ورحمتي وسعت كل شيئ}(الأعراف: 156). وقوله: {كتب على نفسه الرحمة}( الأنعام 12 و54)، وقوله: { وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين}(سورة الأنبياء: 107). ولا أريد هنا الإكثار من إيراد الآيات التي يرد فيها مفرد الرحمة أو فعلها؛ إذ لا يكاد يفوقها أو يماثلها في ذلك في القرآن إلاّ مفرد المعروف. وفي كتابٍ حديث الصدور لأنجليكا نويفرت، الباحثة الألمانية الكبيرة في دراسات القرآن، توردُ ستة عشر مفرداً لها معنى الرحمة في الكتاب المُبين، مما يدفعها للذهاب إلى أنّ القرآن بين الكتب المقدسة، هو كتابُ رحمةٍ بالفعل. وهكذا فإنّ هذا الواقع ليس اكتشافاً من جانبي؛ بل إنّ المتكلمين المسلمين في العصور الوسطى اختلفوا عليه أو اختلفوا في تراتُبية القيم؛ فقالت المعتزلة إنّ القيمة العليا في الدين هي العدل؛ بينما ذهبت الأشعرية إلى أنّ القيمة العليا هي الرحمة. وفي سياق الجدال الذي استمر قروناً اضطرت المعتزلة إلى إدخال اللطف الإلهي إلى جانب أصل العدل، لتواجه بشكلٍ أكثر إقناعاً مقولة الأشعرية في الرحمة والعناية والفضل. وبالطبع فإنّ سياقات القرون الوسطى مختلفةٌ كثيراًعن سياقاتنا المعاصرة. فقد كانت المعتزلة تريد بأصل العدل الدفاع عن حرية الإنسان في ممارسة أفعاله، لكي يمكن اعتباره مسؤولاً عنها بالإثابة أو العقوبة إنْ خيراً أو شراً. بينما كانت الأشعريةُ تريد الدفاع عن مبدأ تفرد الله عزّ وجلّ بالخَلْق والقدرة، وتعتبر الفعلَ الإنسانيَّ كسْباً. وفي كل ديانةٍ من أديان التوحيد هذان المذهبان: مذهب الرحمة، ومذهب العدل، كما بين أوغسطينوس وتوما الأكويني. ولذا فلسْتُ أزعُمُ أنّ الأمر اكتشافٌ من جانبي، ولكنها القراءة التأويليةُ التي تغيّر من فلسفة الدين، ومن رؤية العالم.
ثم إنني لستُ أزعُمُ أنّ هذه الرؤية هي بدون مُشكلات وخصوصاً إذا جرى تأمُّلُها في ضوء مقولات علم الكلام الوسيطة، والمنظومات الفقهية ، وبعض ظواهر القرآن- وهذا إلى الفصامات التي أدخلتها الأصوليات المعاصرة . إذ أين نذهب بحصرية الحقيقة في الدين أو الخلاص، والتي يصرُّ عليها التيارُ الرئيسي في اليهودية، وما تزال مشكلةً كبرى في الكاثوليكية رغم مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965) ومقرراته. أمّا في البروتستانتية فما ظهرت فيها على كثرة فرقها مقولة قوية تتخلى عن حصرية الحقيقة. والحصرية هذه شديدة التجذر في فقه الدين عندنا. ثم هناك بعض السُوَر القرآنية مثل سورة براءة، وبعض الآيات في سورة الأنفال وغيرها، تحتاج إلى قراءاتٍ جديدةٍ في المفردات والسياقات للتلاؤم أو الاندراج في هذه المقولة الكبرى.
إنّ مقولة الرحمة راجحة بل مؤكدة باعتبارها فلسفةً للدين الإسلامي، والرؤية فيه اعتبار تلك القيمة مناط علاقة الله بعباده. وقد صرّح القرآن بذلك في وصف رسالة رسوله صلواتُ الله وسلامُهُ عليه. وقد قلتُ إنّ المتكلمين أدركوها على تردد وفي سياقاتٍ أُخرى. ثم لننظر هذه المقولة الشاملة باعتبار الله سبحانه خالقاً لسائر البشر، وهو الرحمن الرحيم، فكيف لا تنالُ رحمته سائر مخلوقاته. ولننظر أيضاً في هذه النزعة لبعض المتكلمين الذين يقولون بفناء الجنة والنار. يقولون ذلك طبعاً لأنه يبقى وحسب وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكنّ الفلسفة من وراء ذلك أنه حتى في الآخرة، ليست هناك عقوبة أبدية، لأنّ رحمة الله سبحانه سبقت غضبه كما جاء في الحديث القدسي.
إنّ الإيمان يفعل العجائب عند المسيحيين وعند أهل السنة. ولذلك تتراجع قيمة الأعمال الصالحة في هذه النقطة؛ لا من حيث ضرورتها، بل من حيث إنّ تخلُّفها لا يؤدي إلى زوال الإيمان. لأنّ الأمل بالتوبة، والأمل برحمة الله وتسديده يظلُّ قوياً وقائماً.
وبالنظر لكل هذه الاعتبارات الإبستمولوجية واللاهوتية والتأويلية لا بد من الاتجاه لاستكشاف هذه الإمكانية الجديدة في الدين وللدين. ثم إننا نستطيع القول بتهيبٍ واستغاثة إننا نحن المسلمين اليوم من بين كل أهل الأرض محتاجون إلى رحمة الله وعنايته، وإن لم نلتمسْها في ديننا ولديننا فأين نلتمسُها؟
إنّ الرحمة، هي معنى ومعيار العلاقة بين الله سبحانه وبني البشر. ويفضّل الصوفية أو بعضهم المحبة أو الرضا. والذي أراه أنهما وجهان من وجوه الرحمة التي لا تكاد تنحصر.
وهذا الأمر أو المذهب يقول الكثير عن طبيعة الدين باعتباره دين سلامٍ مع نفسه ومع العالم.
- المقولة الثانية: مقولة التعارف. { يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم}(سورة الحجرات: 13). القرآن يقرر أنّ العلاقات بين البشر تقومُ على التعارُف. والتعارُف أعلى وأغنى وأكثر إنسانيةً من الاعتراف. وتعالوا قبل التفصيل ننظر في هذه اللام العجيبة في: لتعارفوا . هل هي لامُ السببية والتعليل أم هي لامُ العاقبة. ولامُ العاقبة تعرضُ في الظاهر نتيجةً غير منطقية. ففي القرآن: { فالتقطه آلُ فرعونَ ليكونَ لهم عدواً وحزنا}(سورة القصص: 8). وبالطبع فإنّ احتضان الطفل موسى من جانب آل فرعون ما كان الهدف من ورائه أن يكونَ عدواً لهم بل ابناً متبنًى، لكنّ النتيجة لم تتطابق مع المقدمة وهي الإنقاذ والاحتضان. فهل تكونُ لامُ: لتعارفوا، لامَ عاقبة، بمعنى أنه رغم الاختلاف الشديد في الخلق والتنظيم الاجتماعي، فإنّ التعارف حاصلٌ على سبيل التكامُل، أو يكونَ كل فردٍ أو كل مجموعة ناقصة. أو تكون اللام لامَ الأمر، أي لكي تتعارفوا أو لأنه ينبغي أن تتعارفوا، لأنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أنّ التقي هو الذي يحقق التعارف ويُثابُ عليه؟!
هذه الفذلكة قد لا تكون ضرورية. هناك نصٌّ قرآنيٌّ صريح هو أنّ العلاقة بين البشر قائمةٌ على التعارُف. وكل عارفي القرآن يعلمون أنه ما من مفردٍ يرد في القرآن أكثر من مفرد المعروف المقارب في المعنى لمفرد التعارُف وإن لم يكن بوضوحه وإبلاغه. فالإمام الغزالي يقول في "إحياء علوم الدين": إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصلٌ من أصول الدين.
وهنا أيضاً، أي في هذه الفلسفة للعلاقة بين البشر، أي فلسفة التعارُف إشكالات. فالسائد اليوم في العالم، وبين المسلمين، أنّ الإسلامَ دين قوةٍ واعتساف. وقد قضى العلماء قرابة المائة عام وهم يدافعون عن مقولة أنّ الجهاد في الإسلام دفاعي، وما صدّقهم الكثيرون. فلننظر في هذه المسألة أيضاً. هناك الآية الفاصلة: { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتُقسطوا إليهم}(سورة الممتحنة: 8). والبر والقسط يدخلان في معنى التعارُف ووجوهه الكثيرة التي يعبّر عنها مفهوم المعروف. إذ هناك حالتان لا بد من الدفاع فيهما عن النفس وهما: الإكراه على الخروج من الدين، والإكراه على الخروج من الديار. وفيما عدا ذلك ليس هناك قتالٌ واجب، ولو امتلكْتُ الشجاعة الكافية لقلت: ليس هناك قتالٌ جائزٌ.
إنما ماذا نفعل بهذا الموروث الهائل من أدبيات الجهاد؟ وماذا نفعل مع الفتوحات الضخمة، والإمبراطوريات الهائلة؟ إنّ شأننا في ذلك شأن الأُمم الأُخرى، ويمكننا القول كما قال الشعبي للحجاج: ما كنا بالبررة الأتقياء ولا بالفجرَة الأقوياء! علينا أن نقرأ تاريخنا ونصوصنا لا بعيون الإنكار أو التقديس، لكن ينبغي أن نفهم ونتعقل ونتجاوز، لزمنٍ جديدٍ وعهدٍ جديدٍ، ماعُدْنا كما كنا لا في موازين الأقوياء ولا حتى الضعفاء، وواحسرتاه، أصغوا معي لقوله تعالى: { وأذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعَفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون}(سورة الأنفال: 26).
إنّ التعارُف هو رسالةُ سلامٍ إلى العالم، إلى سائر بني البشر. وهو أرفعُ من الاعتراف، فأنتم تعرفون أنّ الاعتراف هو في الأصل وسيلةٌ لدى الكنيسة للتكفير عن الذنوب. ثم صار فلسفةً دخلت في النسبية الثقافية، فصار ذلك قيمةً عليا في تدبير الاختلاف، ووصل العلاقة بين البشر. إنه مثل التسامح، فيه غضاضةٌ، وفيه خروجٌ من الإنكار وإن يكن المرءُ مُرغماً. أما التعارف فهو عملٌ إنسانيٌّ للتكامل وصنع الخيرات المشتركة: { ولكلٍ وجهةٌ هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا}(سورة البقرة:148). فالتعارفُ وجهةٌ أو اتجاهٌ يختاره المرء بالحرية وبالطبيعة الإنسانية، ويتقصد من وراء ذلك التكامل في إنسانيته وصُنْع الخير. ولذلك فهو رسالةُ سلامٍ إلى العالم وقد فات المفكرين المسلمين الإصلاحيين من قبل. لكنهم اندفعوا باتجاهه في العقدين الأخيرين.
إنّ القول بالمعروف والتعارف قولٌ بأخلاق وقيم إسلامية وإنسانية وعالمية، وهذا الذي ينبغي العمل عليه بدون تردد.
- والمقولة الثالثة: هي مقولةُ مقاصد الشريعة. وهي تحدّد الوجوه والمجالات المتصلة بصون الوجود الإنساني، والتي يكون على المسلمين بمقتضى التعارُف، وبمقتضى القيم المشتركة أن يؤدّوها لأفرادهم ومجتمعاتهم، وللناس أجمعين. وهي بحسب الفقهاء خمس ضروراتٍ أُنزلت الشرائع لصونها: حق النفس، وحق العقل، وحق الدين، وحق النسْل، وحق الملك. وقد قلتُ من قبل إنّ العلماء المسلمين المُحدثين اكتشفوها في القرن التاسع عشر في كتاب الموافقات للشاطبي، وطُبع الكتاب بمطبعة الدولة بتونس عام 1884، وحمله الشيخ محمد عبده في حقيبته طوال حياته. ثم أعاد أحد تلامذته طبعه بعد وفاة الشيخ. وأعاد طرحه وتجديده كلٌّ من الطاهر بن عاشور في الأربعينات وعلاّل الفاسي في الستينات والسبعينات. وقد استخدمت المقاصد بعدة وظائف خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وتراجعت استخداماتُها في فترة الصعود الأصولي والإحيائي. إنما منذ الثمانينات صارت توظف للشراكة والتواصُل مع العالم. وقد انطلقت منها عشرات الإعلانات الإسلامية لحقوق الإنسان. وقد اعتبرها عدةُ دارسين أساساً لنظرية القيم المشتركة بين الأديان والثقافات، واعتبرها العلاّمة بن بية وشيخ الأزهر رسالة التزامٍ وسلامٍ مع العالم. وهي تحتاجُ في الشرح إلى تفاصيل كثيرة، ولأنّ المجال يضيقُ عن ذلك في هذا المعرض، فسأتوقف عند هذا الحدّ، فلنتأمل جيداً في هذه المشتركات من ناحيتين: لناحية الانفتاح الكامل على"المعروف" الإسلامي والعالمي، ولناحية اعتبارها: أخلاق عمل يقترحها الدين، بل ويكلّف بها.
وأختم ببعض الملاحظات:
أولاً: إنّ هذه المحاولة بشأن المقولات الثلاث هي اجتراحٌ لسرديةٍ جديدةٍ في فلسفة الدين الإسلامي. والمقصودُ بها أن تكون رسالة ودعوةً لاستعادة السكينة في الدين، وصنع السلام مع العالم.
ثانياً: كل العناصر أو المقولات الواردة جرى التعرض لها من جانب الإصلاحيين العرب والمسلمين خلال أكثر من قرن. وليس لي إلاّ التركيب المستند إلى التأويلية أو السردية الشاملة التي ذكرتها. وهي تحتاج بعد إلى عملٍ كثير.
ثالثاً: إنّ التأويل ليس منهج ضرورة ولا ابتداع في الدين أو النصوص الكلاسيكية أو الحاضرة. بل هو منهج تفتيحٍ لإمكانيات النصّ، وبخاصةٍ النصوص الدينية أو المقدسة. والتأويلية هنا لا تبدو في مفردات السردية، بقدر ما تبدو في تركيبها أو تحويلها إلى منظومة.
رابعاً: هناك فرقٌ ظاهرٌ بين التأويل والتأصيل. فالتأويل يراعي المفرد والنظمَ والسياق وطبيعة المنظومة؛ بينما يعتبر المؤصِّل أنّ النصَّ الذي يرجع إليه يتضمن كل شيءٍ بحروفه، ودونما تأويلٍ أو تفسير- كما أنّ مسائل نقد النص والتي استغرقت كل التاريخانيين لا تُعيننا هنا في شيئ. ولذلك، وفي ظروف الأزمنة المأزومة التي نمر بها، كثر التقاذف بالنصوص، وقتل الناس بها من جانب إدارات التوحش.
خامساً: وأخيراً: أردْتُ من هذا النظم أن يكون رسالة سلامٍ وتصالُحٍ مع النفس ومع العالم، وهذه القيم هي مقتضى ديننا بالفعل، هذا ما أُومن به. لكنّ الرسالة تحتاج كما سبق القول للمزيد من العمل البحثي، والمزيد من القراءة النقدية لكل ما أحاط بمفرداتها قديماً وحديثاً. وكما سبق القول فإنّ كلَّ مسعىً اجتهادي من جانب فقهاء الجماعة وعقائدييها إنما يتوحى التوصل إلى إجماعٍ في كل عصر، إجماع على "المعروف" تحديداً أو إعادة تحديد، وإنفاذ أواقتناع في أوساط الجمهور. فالأمر لا يحتاج إلى بحوثٍ فريدةٍ فقط؛ بل يحتاج أيضاً إلى إرادة نهوضٍ ووعيٍ جديد يتقصد الملاءمة بين فقه العيش المتغير، وفقه الدين المتغير أيضاً، وهكذا فقد صار الأمر يحتاج إلى تغييرٍ في رؤية العالم، وإلى فلسفةٍ جديدةٍ للدين. وما قمت به هو جهد المُقلّ. وبالله التوفيق